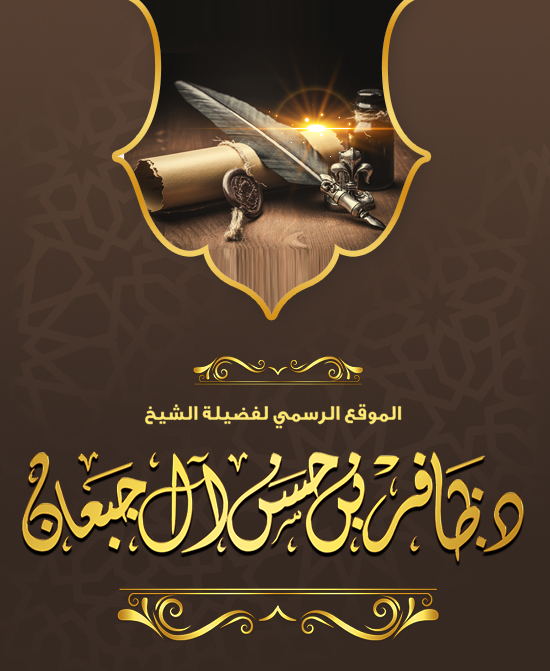۩ القائمة الرئيسية ۩
۩ فوائد علمية ۩
۩ القصص الدعوية ۩
۩ البحث ۩
۩ الاستشارات ۩
۩ إحصائية الزوار ۩

۩ التواجد الآن ۩
يتصفح الموقع حالياً 40
تفاصيل المتواجدون
هدايات الآية (196) من سورة البقرة
القرآنية والتجويدية
هدايات الآية (196) من سورة البقرة

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
هدايات الآية (196) من سورة البقرة:
﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا
تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ
مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ
صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى
الْحَجِّ﴾.
1- ﴿وَأَتِمُّوا
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾، الآيةُ على ظاهرِها، مَن
دخل في الحجِّ، أَو العُمرةِ فيلزمُه الإتمامُ، وإِن كانت نافلةً، فإِذا أَحرم الرَّجلُ،
أَو المرأةُ بالحجِّ، أَو بالعُمرةِ فإنَّه يلزمُهما الإِتمام، بخلافِ النَّوافلِ الأُخرى،
فمن شَرع في الصَّلاةِ النَّافلةِ وعَرض له ما يدعوه لقطْعها فله أَن يقطعها، وكذا
صومُ النَّافلةِ، وغيرِها مِن النَّوافلِ، مع كراهةِ قطعها لغيرِ حاجٍّ، لكنَّ
الحجَّ والعُمرةَ مَن شرعَ فيهما؛ فعليهِ الإِتمام ولو كانا نافلتين، فمتى شَرع
فيهما، أَو في أَحدِهما؛ وجب الإِتمام.
2- ﴿لِلَّهِ﴾ يدلُ
على الإِخلاص للهِ Y، فهذا تذكيرٌ بالتَّوحيدِ قبلَ الشَّروعِ بذكرِ الأَحكام التَّفصيليَّةِ،
هذا تذكيرٌ بالإِخلاصِ وتنصيصٌ على أهميته في الأعمال والعبادات، لاسيما الحجُّ
والعمرةُ.
3- ﴿فَإِنْ
أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، إذا أُحصرَ مَن أَحرمَ بحجٍّ أَو عمرةٍ لأَيِّ سببٍ كان، سواءٌ مِن
عدوٍ، أَو مرضٍ، أَو فُقدان نفقةٍ، أَو تضييع الطَّريق، أَو غيرِ ذلك، أَهدى حيثُ
أُحصر، وحلَق، وتحلَّل مِن إِحرامه.
4- ﴿فَإِنْ
أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، على مَن دَخل في النُّسكِ أَن يستَّمر في نُسكِه، فلا يقطعُه إِلا
بالإِحصارِ، فإِذا أُحصرَ فعند ذلك يكونُ كما أَمر اللهُ Y يذبحَ فديةً أَو
هديًا، ويُوزَّع في المكانِ الَّذي هو فيه ثمَّ يحلقُ أَو يُقصر، فمن إِتمامِ الحجِّ
والعمرةِ ظاهرًا الاستمرارُ في أَعمالِهما والبقاءِ على الإِحرام، وكذلك إتمامُ أَعمالِ
الحجِّ والعمرةِ على الوجهِ المشروعِ، وأَما باطنًا فيكونُ ذلك بالإخلاصِ للهِ
تعالى.
5- قال تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾،
ولم يقل: (فإذا أُحصرتم)، والفرقُ بينهما أَنَّ "إِنْ" تُقال فيما يقعُ
قليلًا أَو نادرًا، وأَمَّا "إِذا" فتكونُ لما يقعُ كثيرًا، وهذا
باعتبارِ أَنَّ الإِحصارَ إِنَّما يكونُ وقوعُه قليلاً فَإِنْ
أُحْصِرْتُمْ فالأَصلُ عدمُ الإِحصارِ، ومَن هنا ذَهب بعضُ أَهلِ العلمِ إِلى
أَنَّه يُكره في النُّسك عند الإِحرامِ أَن يَشترطَ مِن غيرِ عُذرٍ.
6- ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، فيه دِلالةٌ أَنَّ مبنى الشَّريعةُ قائمٌ على التَّيسير، فتأَمل
في قولِه تعالى في آياتِ الصَّيامِ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة:185]، وتأملَ في قولِه تعالى في آية التَّيمُّمِ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة:6]، فهذه الشَّريعةُ بأَحكامِها
وتشريعاتِها مبناها على الرِّفق والتَّيسيرِ، فهنا ﴿فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، الَّذي يتيسرُ له من الهَديِّ:
شاةٌ، أَو بقرةٌ، أًو بدنةٌ مِن الإِبلِ كلُّ ذلك يُجزئُ.
7- المُحصَرُ إِذا تَعسَّر عليه الهَديُ أَو ثمنُه فلا شيءَ علِيه؛
لأَنَّ اللهَ U لم يذكر بديلًا عنه؛ وقيل: عليه صيامُ عشرةِ أَيام، قياسًا على
هديِّ التَّمتعِ -وهذا مع مخالفته لظاهر الآية- هو أيضًا قياسٌ مع الفارق؛ لأَن
تحلُّلَ المتمتع تحلُّلٌ اختياري، بينما تحلُّلُ المُحصَرِ تحلُّلٌ اضطراريٌّ.
8- ظاهرُ الآيةِ عدمُ وجوبِ الحَلق على المُحصَرِ، عندَ التَّحلُّلِ
لعدمِ ذكرِه، لكن دلَّت السُّنَّة على وجوبِه، كما في حديث أُمِّ سَلَمة رضي اللهُ
عنها.
9- ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾، هذا نهيٌ، والأَصلُ أَنَّ
النَّهي للتَّحريمِ إِلا لصارفٍ، فهو يَدلُّ على أّنَّ حَلقَ الرَّأسِ لا يَجوزُ
للمُحرمِ إِلا إِذا بَلغ الهَديُ محِلَّهُ، وذلك في يومِ النَّحر، والتَّقصيرُ
كالحَلقِ لكنَّه ذكر الحَلق وحدَه، ولم يقل: (ولا تُقصِّروا)، مع أَنَّ التَّقصيرَ
لا يجوزُ حتَّى يبلغَ الهَديُ محلَّهُ، ففَهم بعضُ أَهلِ العلمِ مِن ذلك الإِشارةُ
إِلى أنَّ الحَلقَ أَفضلُ مِن التَّقصيرِ، يعني أَنَّه ذَكر الحَلق ولم يَذكُرِ
التَّقصيرَ مع اتحادِهما في الحُكم، لأَنَّ الحَلقَ أَكملُ وأَفضلُ فذكر أَكملَ
الأَمرينِ، وقد قال النَّبيُّ r كما في الصَّحيحينِ: «اللَّهمَّ اغفر للمحلِّقينَ«، قالوا يا رسولَ اللَّهِ والمقصِّرينَ. قالَ: «اللَّهمَّ اغفر للمحلِّقينَ ثلاثًا«. قالوا يا رسولَ اللَّهِ والمقصِّرينَ. قالَ: «والمقصِّرينَ«، فبهذا يُعلمُ مِن القرآن على هذا الطَّريق في الاستنباط أَنَّ
الحلقَ أَفضلُ مِن التَّقصير، وأَمَّا الدَّليل مِن السُّنَّة فهو ما ذُكر آنفًا.
10- ﴿فَمَنْ
كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ
أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، فهذا يدلُ أَيضًا على التَّيسيرِ
والتَّخفيف، وأَنَّه ما جعلَ علينا في الدِّين مِن حرجٍ، فإِذا كان الإِنسانُ
يحتاجُ إِلى الحَلق أَو إِلى شيءٍ مِن محظوراتِ الإِحرامِ لعذرٍ معتبرٍ فإِنَّه
يفعلُ ويكونُ عليه فديةُ أَذىً، وفديةُ الأَذى كما قال تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾،
ففديةُ الأَذى هي الَّتي يُخيَّر فيها بين هذه الثَّلاثةِ: صيامٍ، أَو صدقةٍ، أَو
نُسكٍ، لاحظ هنا ذكر ثلاثةَ أَشياء، الصَّدقةُ تكونُ لفقراءِ الحرمِ أَن يُطعم ستَّةَ
مساكينٍ، والنُّسكُ الذَّبيحةُ أَيضًا لفقراءِ الحرمِ في فديةِ الأَذى، ففديةُ الأَذى
هذه تكونُ لفقراءِ الحرمِ، فذكر هنا ثلاثةَ أَشياءٍ؛ اثنين منها تكون للمحتاجينَ
والفقراءِ، فدلَّ على عنايةِ الشَّارعِ بهذا الجانبِ، وكما قال الله تعالى: ﴿وَأَطْعِمُوا
الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج:36]، ﴿وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج:28]، فدلَّ على أَنَّ إِطعامَ الطَّعامِ والإِحسانَ إِلى المساكينِ والفقراءِ والمحتاجينَ مِن فضائلِ الأَعمالِ،
لاسِيَّما في الحجِّ، فقد شرَّع اللهُ -تبارك وتعالى- من التَّشريعاتِ ما يكونُ
سببًا للإِحسانِ إِلى هؤلاء، وسدِّ جَوعتِهم.
11- في التَّخييرِ بين خِصال الكفَّارة تيسيرُ على العبادِ، وفي جعلِ
الصَّدقة والنُّسكِ مِن بينها دِلالةٌ على حِرص الشَّرعِ المطهرِ على الأَعمالِ الَّتي
يتعدى نفعُها إِلى الآخرينَ، ونفعُ المحتاجينَ.
12- ﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ جوازُ
التَّمتعَ بالعُمْرةِ إِلى الحجِّ؛ وهو أَن يأتي بالعُمْرة في أَشهرِ الحجِّ، ثمَّ
يتحلَّلُ منها تحلُّلًا كاملًا، ويتمتَّعُ بما كان محظورًا عليه بالإِحرامِ، إِلى
أَن يُحرم بالحجِّ، وهو أَفضلُ الأَنساك، لأمره r مَن لم يَسُقِ الهدي مِن أَصحابِه بالتَّحلُّلِ مِن عُمْرتهم،
وقوله r: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ
من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ؛ ما أَهْدَيْتُ، ولولا أَنَّ معي الهَدْيَ
لَأَحْلَلْتُ« [متفق عليه].
13- وجوبُ الهدي على المتمتِّعِ بالعُمْرة إِلى الحجِّ؛ لقولِه تعالى:
﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ﴾؛ أَي مِن الهديِّ الشَّرعيِّ؛
شاةٌ أَو سُبُعُ بدنة أَو سُبعِ بقرةٍ شُكرًا للهِ U على نعمةِ التَّحلُّلِ والتَّمتع بين النُّسكين، وحصولِهما في سفرٍ
واحدٍ، ومثلُه القارنِ في وجوبِ الهدي عليه، لحصولِ النُّسكين له في سفرٍ واحدٍ، أَمَّا
المفردُ فلا هدي عليه واجبٌ.
14- في إِيجابِ الهدي على المتمتِّع دِلالة على فضلِ إِهراقِ الدَّمِ،
وحرصِ الشَّارع على ما يتعدَّى نفعُه إِلى الآخرينَ مِن المحتاجينَ وغيرِهم.
15- ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾، على مِن لم يجدِ
الهَديَ أَو ثمنِه صيامَ ثلاثةَ أَيامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إِذا رَجع إِلى أَهلِه.
ووقتُ صيامِ الأَيامِ الثَّلاثةِ
منذ أَحرمَ إِلى يومِ عرفة، فإِن لم يصمْها قبلَ العيد صامها أَيامَ التَّشريقِ
الثَّلاثَة، لحديث عائشةَ وابنِ عمرَ رضي الله عنهما قالا: (لم يُرَخَّص في أَيَّامِ
التَّشريقِ أَن يُصَمْنَ، إِلَّا لِمن لم يجدِ الهديَ) [أخرجه البخاري].
ووقتُ صيامِ الأَيامِ السَّبعةِ إِذا رجعَ إِلى أَهلِه، وإن صامها
بعدَ أَن أَنهى أَعمالَ الحجِّ، في مكةَ، أَو في الطريق أجزأه ذلك.
16-
﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾، تأكيدُ وجوبِ إِكمالِ صيامِ هذه الأَيَّامِ، وإتمامِها عشرةٌ.
17-
﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ
حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾،
عدمُ وجوبِ الهديِّ، أَو الصِّيامِ على حاضري المسجدِ الحرامِ.
18- ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾، راقبوه في أَعمالِكم، واخشَوْه أَن يَرى في أعمالِكم نقصًا ظاهريًّا أَو معنويًّا، وعُدوانًا في مناسكِكُم، أَو رجوعًا إِلى الوثنيَّةِ الجاهليَّةِ مِن عبادة الموتى، واعتقادَ البركةَ في الأَحجارِ والأَشجارِ، يحاولُ الشَّيطانُ أَن يُبطل بها أعمالَكم، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ لِمن يتعدَّى حدودَه، أَو يعودَ للجاهليَّةِ بعمله أو عقيدته؛ كمثلِ ما يصنعُه كثيرٌ مِن العوامِ في التَّمسحِ بالحديدِ المنصوبِ على مقامِ إِبراهيمِ، وتقبيلِ كلِّ جدران الكعبةِ وكسوتِها، والتَّمسحِ بها، وأَخذِ البركةِ -بزعمهم- منها، وأخذِ خيطٍ يقيسون به مقامَ إِبراهيمَ أَو بابِ الكعبةِ يعقدونَه عقدًا؛ يعتقدون أَن من تعلَّقَتْ ذلك الخيط تَحمَلُ ولو كانت عقيمًا، وكذلك تقبيلُ شُبَّاكِ النَّحاس المُقام على القبرِ الشَّريفِ، ودعاءِ رسول اللهِ r بدعاءِ المشركينَ لآلهتِهم؛ مثلُ: يا رسولَ اللهِ، اشفعْ لي، يا رسولَ الله، أَغثني، يا رسولَ الله، أَنتَ لها ولكلِّ كربٍ؛ فكلُّ ذلكَ وأَمثالَه عُدوانٌ أَشدَّ عُدوانٍ، وظلمٌ أَشدَّ ظلمٍ، يُعاقِبُ اللهُ عليهِ أَشدَّ العِقابِ، فإِنَّ مَن هذا فِعلُه فهو تحقيرٌ للكعبةِ، وإِهانةٌ للمشاعرِ، وإيذاءٌ للهِ ولرسولِه.
_ _ _